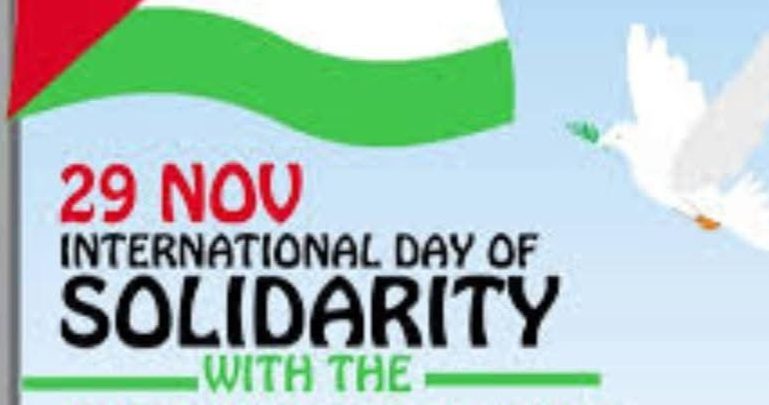
من التقسيم الى الثوره الى الانتفاضة الى غزة كيف تحوّل التضامن الدولي إلى أكبر حركة أخلاقيّة في القرن؟
بقلم المخرج الفلسطيني ( يحيى بركات )
«هكذا صنع الفلسطيني يوم 29/11… بدمه، بثورته، بوعيه، وبصلابة سبعون عامًا»
يومٌ صنعه التاريخ، وصاغته دماء الجرحى والشهداء، ووقّع عليه الأسرى،
حين وقفت شعوب العالم وقالت:
«لسنا محايدين أمام فلسطين».
هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، كأنها سلسلة أفلام طويلة، نعود فيها إلى البدايات كي نفهم اللحظة، ونفهم لماذا أصبح 29/11 اليوم الأكبر في الذاكرة الأخلاقية للعالم.
من أين جاء هذا اليوم أصلًا؟
29 تشرين الثاني/نوفمبر
ليس رقمًا جميلًا في التقويم فقط.
إنه التاريخ الذي صوّتت فيه الأمم المتحدة عام 1947 على قرار التقسيم 181، القرار الذي مزّق الجغرافيا وشرعن الظلم، حين منح الحركة الصهيونية أكثر من نصف أرض فلسطين في وقت كان الفلسطينيون هم الأغلبية الساحقة من السكان، ولم يكن اليهود يملكون سوى جزء صغير من الأرض.
بعد ثلاثين عامًا تقريبًا، عام 1977، عادت الجمعية العامّة للأمم المتحدة إلى التاريخ نفسه، وقالت للعالم: هذا اليوم يجب أن يتحوّل إلى يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني،
لا للاحتفال بالتقسيم. فأقرّت القرار 32/40 (ب) الذي جعل من 29/11 «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، في إشارة صريحة إلى أن ما بدأ كجريمة تقسيم يجب أن ينتهي إلى عدالة وحق تقرير مصير.
الأمم المتحدة لم تكن تريد حصر التضامن في يوم وحيد، لكنها احتاجت إلى رمز، إلى تاريخ تقول فيه رسميًا: هناك شعب حُرم من دولته ومن عودته، وهذه مسؤولية العالم، لا مسؤولية الضحية وحدها.
لكن الحقيقة أن يوم 29/11 لم يصنعه قرار أممي فقط…
يوم 29/11 صنعه الفلسطيني نفسه، منذ لحظة قرّر فيها أن يخرج من الخيمة والانتظار، إلى البندقية والراية والجامعة والمخيم، وأن يحوّل قضيته من ملف لاجئين إلى ثورة تحرّر.
منذ الأول من كانون الثاني 1965، يوم انطلقت أول رصاصة للثورة الفلسطينية الحديثة، تغيّر المشهد كله.
لم يعد الفلسطيني «لاجئًا صامتًا» في صور الصحافة، بل مقاتلًا يحمل اسمًا ووجهًا وقصة، ينتمي إلى خريطة أوسع اسمها: حركات التحرر في العالم.
العالم في الستينات كان يغلي:
فيتنام تقاتل، الجزائر خرجت من الاستعمار، كوبا رفعت راية شي غيفارا، أفريقيا تنتفض من أنغولا إلى موزمبيق، والطلاب يملأون شوارع باريس وروما ولندن.
وسط هذا الموج، ظهرت فلسطين كقضية تلخّص كل شيء: استعمار استيطاني، تطهير عرقي، لاجئون، مقاومة، ثورة، ووعد بدولة مستقلّة.
في ساحات الجامعات الأوروبية، كانت صور جيفارا تُعلّق إلى جانب صور الفدائي الفلسطيني؛
في أروقة الأحزاب اليسارية في إيطاليا وفرنسا، كانت فلسطين تُذكر كما تُذكر فيتنام؛
وفي موسكو وهافانا وهافانا وبلغراد، كانت منظمة التحرير الفلسطينية تُستقبل كحركة تحرّر حقيقية، لا كوفد بروتوكولي.
لم يكن التضامن العالمي مع فلسطين إحسانًا، بل اعترافًا:
«هذه ثورتكم، وهذه ثورتنا أيضًا.»
من منتصف الستينات حتى أوائل الثمانينات، كانت قواعد الثورة الفلسطينية في الأردن، ثم في لبنان، أشبه بمختبر حيّ للتضامن العالمي.
لم يكن الزائر الأجنبي يأتي لالتقاط صورة مع الكوفية والرشاش، بل كان يأتي ليعمل، وليتغيّر، وليعود إلى بلده وهو يحمل فلسطين في وعيه إلى الأبد.
هناك أطباء تركوا مستشفياتهم المريحة في كندا وأوروبا، وجاؤوا ليعملوا مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيمات لبنان.
أحدهم د. كريس جيانو/جيانو، الجرّاح الكندي من أصل يوناني، الذي أسّس مستشفيات ميدانية للهلال الأحمر في صيدا وبيروت، وعاش حصار 1982 بكل تفاصيله، وأسِرَته قوات الاحتلال ثم شهد بعدها على ما رآه من انتهاك فاضح لاتفاقيات جنيف، وجعل من شهادته جزءًا من ذاكرة التضامن الطبي مع فلسطين.
كان هناك من يشبهونه: أطباء من بريطانيا وإيطاليا واليونان والدنمارك، ممرضات من النرويج وهولندا، معالجون نفسيون من أمريكا اللاتينية، مهندسون يساعدون في بناء المدارس والعيادات في المخيمات، متطوّعون يعملون في الهلال الأحمر نهارًا، ويكتبون لصحف بلادهم ليلًا عن حقيقة ما يجري.
وفي الجهة الأخرى من الكاميرا، كانت السينما تشقّ طريقها كجزء من هذا التضامن الأممي.
جان لوك غودار، أحد أهم مخرجي الموجة الجديدة في فرنسا، جاء إلى الأردن ولبنان بين 1969 و1970 ليصوّر مشروعه «حتى النصر» عن الثورة الفلسطينية، مشروعٌ تحوّل لاحقًا إلى فيلم «هنا وهناك»، الذي يضع صورة المقاتل الفلسطيني في مواجهة صورة العائلة الأوروبية أمام التلفزيون، ويسأل: من يملك الصورة؟ ومن يملك الحقيقة؟
في روما، كانت أحزاب اليسار ومؤسسات السينما التقدمية تفتح أبواب معاملها لمونتاج أفلام الثورة الفلسطينية، وتشارك في إنتاج أفلام مثل «تل الزعتر»، الذي وثّق، بعدسة فلسطينية وإيطالية مشتركة، واحدة من أبشع المجازر في تاريخ المخيمات.
وفي بيروت، بين 1977 و1982، عملت المخرجة الإيطالية مونيكا مورر مع وحدة أفلام منظمة التحرير على ستة أفلام وثائقية، توثّق البنية الاجتماعية والطبية والثقافية للمخيمات وقواعد الثورة، كجزء من مشروع جماعي لبناء صورة لدولة ديمقراطية علمانية عادلة في المستقبل.
وفي لندن، كانت فانيسا ردغريف، الممثلة العالمية، تقف أمام الكاميرا في فيلم «The Palestinian» عام 1977، لتروي، بصوتها وضميرها، حكاية شعب حُرم من حقه، وتربط بين خشبة المسرح وشوارع المخيمات.
لم يكن أولئك مجرّد «متضامنين»، بل شركاء في صناعة ذاكرة عالمية جديدة لفلسطين.
ذاكرة لم تكتبها وكالة أنباء رسمية، بل كتبها الثائر والطبيب والمخرج والعامل والموسيقي، كتفًا إلى كتف.
هذا التضامن لم يكن أوروبيًا فقط.
العرب أنفسهم، من العراق وسوريا ولبنان ومصر وتونس والمغرب، التحقوا بالثورة الفلسطينية، لا ضيوفًا بل كوادر.
في السينما، نرى أسماء مثل قيس الزبيدي، وقاسم حول،وعرب لطفي ،
ونبيه لطفي ،
ومحمد توفيق، وحكمت داوود، وجان شمعون، وفؤاد زنتوت، وآخرين، يعملون داخل مؤسسات السينما الفلسطينية، يوثّقون المعارك، والتهجير، وحياة الناس في المخيمات، ويحوّلون القضية إلى صور تتحرك على شاشات العالم.
في الإعلام، جاء صحافيون وكتاب عرب ليعملوا في مؤسسات منظمة التحرير، في بيروت ودمشق وقبرص وتونس، يحكون للعالم رواية فلسطينية عربية، لا رواية ترجَمَها الآخرون بالنيابة عن أصحابها.
وفي السياسة، أنشأت الثورة دوائر خاصة للتضامن الدولي، قسمًا لأوروبا، وآخر لآسيا، وثالثًا لأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وكانت ممثليات منظمة التحرير في باريس وروما ومدريد ونيقوسيا وستوكهولم وغيرها، خلايا حيّة لا تهدأ: تنظم الندوات، تُشرف على زيارات الوفود، تنسق مع النقابات والأحزاب والجامعات، وتحوّل كل احتفال أول أيار وكل تظاهرة ضد العنصرية إلى مساحة لفلسطين أيضًا.
لم يكن غريبًا، إذن، أن يصبح هؤلاء الممثلون أهدافًا مباشرة.
عندما يغتال العدو ممثلًا لمنظمة التحرير في باريس، مثل عز الدين القلق ونائبه عدنان حماد عام 1978، فهو لا يقتل «دبلوماسيًا» فقط، بل يحاول قطع شريان من شرايين التضامن الأممي مع فلسطين؛ يريد أن يطفئ الضوء في عاصمة أوروبية كي لا تُرى الحقيقة كما هي.
في الأمم المتحدة، كانت هذه الحركة العالمية تترك بصمتها.
في 1974، وقف ياسر عرفات في قاعة الجمعية العامة، بالكوفية نفسها التي كانت على جباه المقاتلين في الأغوار، وحاملًا البندقية وغصن الزيتون، وقال عبارته الشهيرة: «لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي.»
لم يكن وحده في تلك اللحظة؛ كانت خلفه سنوات من التضامن في الشوارع والجامعات والنقابات والكنائس والمساجد، هي التي دفعت الدول إلى الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني.
بعدها بعام، عام 1975، تبنّت الجمعية العامة قرارها التاريخي 3379، الذي اعتبر الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. لم يأتِ القرار من فراغ؛ لقد كان ثمرة تلاقٍ بين ثورات الجنوب العالمي، وحركات التحرر الأفريقية، وحركات السود في أمريكا، وحركات رفض الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وكلها رأت في المشروع الصهيوني نظامًا استعماريًا استيطانيًا عنصريًا، لا «حلمًا قوميًا بريئًا».
وفي 1977، كما ذكرنا، جاء قرار اعتماد 29/11 يومًا عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كأن العالم يقول:
«نقطة البداية كانت هنا… ولن ننسى.»
بين 1965 و1982، كانت بيروت، خصوصًا، عاصمةً لهذا التلاحم بين الثورة والتضامن.
في الأزقة الضيقة لمخيم شاتيلا وبرج البراجنة وعين الحلوة، كان يمكن أن تسمع في الليلة الواحدة أربع لغات على الأقل: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وربما الإسبانية أو اليابانية أيضًا.
كانت هناك ورشات تدريب عسكرية، إلى جانب ورشات رسم للأطفال.
اجتماعات سرّية للكادر، إلى جانب عروض سينمائية في الهواء الطلق تعرض أفلام الثورة تحت السماء.
مستشفيات ميدانية للهلال الأحمر الفلسطيني يعمل فيها أطباء فلسطينيون وأجانب كتفًا إلى كتف، يكتبون على الحائط بعبارة بسيطة: «هنا لا نسأل عن جواز السفر، نسأل أين الوجع؟».
في هذه المرحلة، اكتشف المناضل الأوروبي والأمريكي اللاتيني والآسيوي شيئًا أساسيًا:
أن الحركة الصهيونية لم تكن يومًا «مشروعًا يهوديًا داخليًا»، بل جزءًا من منظومة استعمارية غربية أوسع، استخدمت المظلومية اليهودية بعد الهولوكوست لتبرير زرع كيان استيطاني في فلسطين، ونقل عقدة الذنب الأوروبية من أوروبا إلى الشرق، وتحويل الفلسطيني إلى «ضحية الضحية».
من هنا، لم يكن التضامن مع فلسطين عاطفة عابرة، بل موقفًا جذريًا ضد نظام عالمي ظالم، يبرّر الاستعمار الجديد بوجه حداثي.
ثم جاءت حرب بيروت 1982، الحصار الطويل، خروج المقاتلين بالسفن، ومجازر صبرا وشاتيلا التي شاهدها العالم مذهولًا.
كثيرون ظنّوا أن خروج الثورة من بيروت يعني نهاية زمن التضامن الأممي، لكن ما حدث كان العكس تقريبًا:
تحوّلت بيروت إلى ذاكرة،
وتحوّل أطباء الهلال الأحمر، والمخرجات والمخرجون، والطلاب الذين مرّوا بالمخيمات، إلى شهودٍ في بلادهم، يحملون الحكاية معهم إلى الجامعات، إلى النقابات، إلى الشاشات.
منذ تلك اللحظة، أصبح هناك «جيل تضامن» في كل قارة:
جيل لا يرى فلسطين خبرًا في نشرة الأخبار، بل جزءًا من تاريخٍ عاشه أو سمعه مباشرة من مناضلين وجرحى وناجين.
مع اتفاق أوسلو مطلع التسعينات، تلقّت حركة التضامن ضربة سياسية وأخلاقية قاسية.
الخطاب الرسمي الفلسطيني انزاح من منطق التحرر إلى منطق «عملية السلام»،
والأنظمة العربية وجدت في الاتفاق فرصة لتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال،
وبعض قوى اليسار العالمي ارتبك أمام هذا التحوّل،
فتراجعت اللجان القديمة، وتم استبدال لغة «المقاومة» بلغة «المساعدات» و«بناء المؤسسات».
لكن الشعوب لم تنسَ.
ومع انتفاضة الأقصى عام 2000، عاد المتضامنون إلى فلسطين نفسها:
إلى جنين وطولكرم وبلعين ونعلين والخليل والقدس،
شاركوا في قطف الزيتون، وقفوا بجسدهم أمام جرافة تحاول اقتلاع شجرة، ضد جدار يقطع قرية نصفين، تعرّضوا للضرب والاعتقال والإبعاد.
كانوا يعتقدون أحيانًا أن جيش الاحتلال سيرتدع أمام «الأجنبي» الأبيض،
أن هناك في مكان ما «قانونًا دوليًا» سيمنع الجندي من إطلاق النار،
لكن كل وهْمٍ من هذه الأوهام كان يسقط رصاصةً بعد أخرى، واعتقالًا بعد آخر، وضربة بندقية على رأس متضامن جاء يحمل وردة وكاميرا.
بهذه التجربة، اكتشف المتضامنون الغربيون أن إسرائيل ليست «ديمقراطية تحترم القانون» كما قيل لهم طويلًا، بل دولة أبارتهايد فاشية لا تتورّع عن قتل الفلسطيني… ولا عن قتل مَن يقف إلى جواره.
اليوم، ونحن في 2025،
نرى موجة تضامن جديدة، ضخمة، عميقة، مختلفة عن كل ما سبق،
بلغت ذروتها في حرب الإبادة على غزة 2023–2024-2025
ملايين البشر في شوارع لندن وباريس وبرلين ومدريد وروما ونيويورك وسيدني،
طلاب يعتصمون في الجامعات،
فنانون يرفضون الجوائز الملوّثة،
أكاديميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية رسمية،
وحكومات كإسبانيا وأيرلندا والنرويج تعترف بالدولة الفلسطينية وتُوقف صفقات السلاح أو تجمّدها تحت ضغط الشارع والرأي العام.
لكن هذه الموجة الجديدة ليست منفصلة عن الستين سنة الماضية.
إنها امتدادٌ لها،
تراكُمٌ لكل صرخة، لكل فيلم، لكل كتاب، لكل مظاهرة، لكل طبيب أجرى عملية في مخيم، لكل ممرضة مسحت دمعة أم في شاتيلا، لكل مخرج حمل كاميرته إلى الأزقة، لكل طالب وزّع منشورًا في باريس أو كراكاس أو طوكيو.
من التقسيم إلى الثورة،
من الثورة إلى بيروت،
من بيروت إلى الانتفاضة،
من الانتفاضة إلى غزة،
يمشي التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني كخيط واحد طويل، يلتفّ حول عنق المشروع الاستعماري، ويقول له بهدوء قاسٍ:
«ربما تستطيع قتل الجسد، لكنك لن تستطيع قتل الحقيقة.»
يبقى السؤال الأهم:
ماذا نفعل نحن، الفلسطينيين،
بهذا الرصيد الأخلاقي الهائل؟
إذا اكتفينا بأن نشكر العالم ونذرف دمعة امتنان، سيتحوّل التضامن إلى موجة جميلة ثم تنكسر على شاطئ النسيان.
أما إذا تعاملنا معه كقوّة سياسية وثقافية واستراتيجية، فسيصبح واحدًا من أهم أسلحة التحرر في القرن الحادي والعشرين.
نحتاج أن نعيد بناء لغتنا مع العالم:
لغة إنسانية، حقوقية، ثقافية، لا فصائلية ولا شعاراتية،
نخاطب بها ضمير الشعوب،
لا عقود الحكومات فقط.
نحتاج إلى مؤسسات فلسطينية حقيقية، مستقلة ونزيهة، وظيفتها ربط غزة بنيويورك، وجنين بمدريد، والقدس بجامعة فيينا،
إلى سينما فلسطينية وعربية ودولية تواصل ما بدأه جيل السبعينات،
إلى أرشيف ثوري يُنقّب عن الأفلام والوثائق المبعثرة في روما وباريس وبرلين، ويعيدها إلى الضوء كي يرى الجيل الجديد أن التضامن لم يبدأ من «هاشتاغ»، بل من دمٍ وصورة وبندقية وكاميرا.
نحتاج أيضًا أن نحمي هذا التضامن من الاختطاف،
من محاولات الأنظمة والقوى اليمينية في الغرب والشرق لتحويله إلى ورقة انتخابية أو ورقة مساومة،
وأن نبقيه كما وُلد:
موقفًا أخلاقيًا جذريًا، يقف مع الإنسان ضد ماكينة الإبادة، أيًا كان دينه أو عِرقه.
يوم 29/11، إذن، ليس موعدًا للاحتفال البروتوكولي، ولا يومًا نكتفي فيه بنشر صور قديمة وعبارات جاهزة عن «التضامن».
إنه اليوم الذي يلتقي فيه مساران:
مسار الثورة الفلسطينية، بكل تضحياتها،
ومسار التضامن الدولي، بكل موجاته.
في هذا اليوم، يجب أن ننظر في المرآة، نحن والعالم، ونسأل:
هل ما زال 29/11 مجرّد قرار في أرشيف الأمم المتحدة؟
أم أنه صار عقدًا أخلاقيًا عالميًا،
وقّعه الفلسطيني بدمه،
ووقّعته شعوب العالم بضميرها،
ولا يجوز التراجع عنه؟
العدالة لا تُختَزَل في يوم،
لكن يوم 29/11 يذكّرنا، كل عام،
أن العالم، مهما استسلم للحظة للظلم،
يعود في النهاية ليرفع صوته ويقول:
لسنا محايدين أمام فلسطين.
يحيى بركات
مخرج وكاتب سينمائي
29/11/2025
#فلسطين #غزة #يوم_التضامن_مع_الشعب_الفلسطيني #التضامن_الدولي #الثورة_الفلسطينية #من_النهر_إلى_البحر #الضمير_الإنساني
رسالة للقارئ
أصدقائي…
ظهور علامة “السياق غير متوفر”
على منشوراتي حول تاريخ فلسطين ويوم 29/11 ليس صدفة،
ولا خطأ تقنيًا، بل جزء من محاولة دائمة لتقييد الحقيقة وحصرها داخل إطارٍ لا يشبهها.
هذا النوع من التنبيه يظهر فقط حين يقترب النص من جوهر التاريخ…
حين تُعرض صورٌ ووثائق يخشاها الاحتلال، لأنها تهدم سرديّته وتكشف جذور القضية منذ 1947 وحتى اليوم.
لهذا أطلب منكم — بمحبة ومسؤولية — أن تساعدوني في إيصال المقال لأكبر عدد من الناس:
اضغط إعجابًا، علّق، شارك، أعِد نشره، أرسله لمن تعرف.
لأن روايتنا تُحارَب، ولكنها لا تُهزَم…
ولأن الحقيقة لا تبقى حيّة إلا إذا حملها الناس، وتناقلوها، ودافعوا عنها.
29/11 لم يُصنع في مكاتب “التحقق”…
بل صُنع في الميدان، وفي الأمم المتحدة، وفي دماء شعبٍ قدّم للعالم معنى التضامن.
معًا…
لنُفشل هذه الرقابة،
ولنُثبت أن التاريخ لا يمكن شطبه.
يحيى بركات
مخرج وكاتب سينمائي






