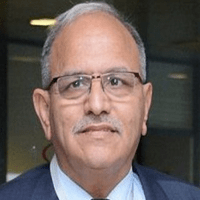سودان ما بعد الفاشر
عبد الوهاب الأفندي
حرير- المفجع حقاً في فجيعة مدينة الفاشر في شمال إقليم دارفور في السودان تكرارها المؤلم فظائع لا تقل بشاعة شهدتها مدينة الجنينة بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2023، وشهد العالم كله معها جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد إثنية المساليت في الإقليم المعروف بـ”دار مساليت”، باعتباره الموطن التاريخي لهذه الجماعة. فقد شهدت الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، وعاصمة سلطنة المساليت التاريخية، هجمات شنّتها مليشيا الدعم السريع بداية من منتصف إبريل 2023. … عندها رأينا “بروفة” لما تشهده الفاشر (عاصمة سلطنات الفور التاريخية) من تقتيل جماعي وتهجير قسري وفظاعات همجية مُنكرة، شملت مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر وبعض أفراد أسرته، في بربرية مقزّزة، والتمثيل بجثته، وذلك بعدما شجب أبكر فظائع المليشيا، وطالب بتدخّل عاجل لوقف تلك الجرائم التي وثّقها المجرمون أنفسهم، إلا أن الانتهاكات لم تتوقف، بل اضطرد الذبح والتقتيل في المدينة قرابة أسبوع، وهُجّر من بقي حياً، في مشاهد زادت من بشاعتها المتلفزة مشاركة أطفال ونساء في الجرائم.
شجب العالم كله عندها تلك الجرائم، وصدرت قرارات من مجلس الأمن وتقارير أممية وحقوقية، ولم يعد هناك عُذرٌ لمشكّك أو مرتاب أو متلجلج، إلا من ختم الله على قلوبهم وسمعهم، وأغشى أبصارهم وبصائرهم. شمل ذلك للأسف بعض من يسمّون أنفسهم “القوى المدنية” الداعية للديمقراطية، من دون أن يمنعها ذلك من أن تصبح جناحاً سياسياً لمليشيا الإبادة والاغتصاب، ومحامية لشياطينها. وها نحن نرى اليوم تكرار تلك الفظائع، وبصورة أبشع ووقاحة أشدّ، من دون أن يكلّ الشياطين ولا من يدافع عنهم.
وبين الجنينة والفاشر كانت العاصمة السودانية وما حولها، وجبل أوليا، ومدني وباقي الجزيرة، وكردفان، والنيل الأزرق وسنار، تتتابع فيها الفظاعات، ومن أبشعها انتهاك الأعراض، واختطاف النساء والفتيات إلى أماكن غير معلومة، وتجنيد الأطفال قسراً، إضافة إلى كل ما في الكتاب من كبائر مشمولة بوعيد سقر وبئس المصير. ولا يملك المبتلى بقدر الإنسانية وأمانتها التي حملها الإنسان الظلوم الجهول إلا أن يتوقّف أمام هذه الطامة الكبرى التي تحوّل الوطن، المكان الذي يأوي إليه الناس ليأمنوا من مخاوف الحياة ومهدّداتها، فيسكنون إلى أسرهم وذويهم وجيرتهم وصداقاتهم، تحوّله إلى جحيم خوف وعذاب، تُجَوَّع فيه وتهان ويهتك عرضك، وينهب مالك، ويأتيك الموت والقهر من كل مكان. وأشد الألم وأعظم الفجيعة في هذا كله أن تجد نفسك عاجزاً عن حماية أطفالك وزوجك وأخواتك ووالدتك من بطش وفجور الفجار، حتى يصبح الفرار بمن تحبّ، تاركاً كل ما تملك، وكل ما تألف وتحبّ، أغلى أمانيك. هذا رغم أنك عندما تفرّ غالباً ما تواجه عذابات أخرى.
والمصيبة في هذا كله أنك لا تجوع لأن الطعام معدوم، ولكن لأن وحوشاً تجتهد لمنعك من نيله ومنعه من الوصول إليك، فكما هو الحال في غزّة، حيث الشاحنات الملأى بكل احتياجاتك مصطفّة غير بعيد، هناك من يقرّر بقوة السلاح أنك لن تطاله، إمعاناً في إهانتك وإذلالك، وحرمانك من أغلى كنوز الأرض، وهي الكرامة الإنسانية، فهو يريدك ألا تحيا إلا عبداً له. ويسمّي الفجار هذا طريقاً إلى الديمقراطية!
والعبودية أنواع، شرّها العبودية للجهل والجهلة. والجهل أنواع، منه جهل المغول والبرابرة الذين اجتاحوا روما والعالم الإسلامي في العصور الوسطى، وهناك جهل العصر الترامبي الذي يؤمن وزير صحته بأن التطعيم (خسرت أميركا سباقه مع أوروبا إبّان جائحة كورونا) مؤامرة شريرة ضد أميركا. وهناك جهل من زعموا أنهم استعمروا العالم حتى ينقلوا إليه الحضارة. ثم هناك جهل قائد مليشيا الدعم السريع حميدتي ورهطه، وعصبة “المثقفين” الذين يتّخذونه إماماً، ولهم عذرُهم، فهو يفوقهم علماً وفهماً، وشرّ العلم ما لا يُنتفع به. ثم بالطبع هناك جهل الزعامات والقيادات العربية والأجنبية التي رأت أن شيخ العلماء ومفتي الديار العربية، مولانا حميدتي، هو من سينقذهم من “الإسلاميين” في السودان.
وقد كنتُ قد وصفتُ الثورة السودانية التي اندلعت في أواخر عام 2018 بأنها أول ثورة علمانية في سلسلة الثورات العربية (تقاربت معها الثورتان العراقية واللبنانية). وكذلك كانت تلك الثورة والنظام الانتقالي الذي تبعها من أكثر العهود شعبيةً داخل السودان منذ الاستقلال، وأكثر نظام وجد إجماعاً في الدعم من المجتمع الدولي ومن أفريقيا والعالمين العربي والإسلامي. حتى حزب المؤتمر الوطني الذي أسقط حكمه ألقى السلم، وقال إنه سيترُك الفترة الانتقالية تأخذ مجراها. ولكن الحكومة الانتقالية (المدنية) أهدرت كل هذا الرصيد في أقل من عامين. أولاً، بسبب خرق رئيس حكومتها ووزرائه تعهداتهم، وفشلهم الاقتصادي الذريع، كان من أولى علاماته تعيين حميدتي رئيساً للجنة الاقتصادية. صحيحٌ أن جائحة كورونا في 2020 كانت كارثة كبيرة عليها، إلا أن وزير صحتها (الطبيب) أثبت جهلاً يحسُده عليه روبرت كيندي الأصغر. أما عن وزير المالية، فحدّث ولا حرج. وقد وقعت الحكومة بين مطرقة المجلس العسكري وسندان الشارع الفوضوي الذي كان يهيمن عليه اليسار المتطرّف، واستسلمت جبناً وعجزاً للطرفين اللذين كانا يجرّانها في اتجاهين مختلفين، كما استسلمت للخارج من شرق وغرب وعرب، حتى لم تعد قادرة على اتخاذ أي قرار قبل مشاورة أبوظبي وواشنطن وبروكسل، ثم “لجان المقاومة”. وكنتُ قد علّقت بأن تلك الحقبة كانت أكثر فترة كبت لحرية التعبير حتى من عهد نظام عمر البشير، فكل قوى المعارضة كانت نشطة في ذلك العهد، إلا أن وزراء حكومة عبد الله حمدوك، بمن فيهم حمدوك نفسه، كانوا لا يجرُؤون على التعبير عن آرائهم بحرية. وقد استضاف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمراً لأكاديميين وإعلاميين ومثقفين وسياسيين، جلهم من أنصار الحكومة الانتقالية التي كانت في نزعها الأخير، لمناقشة أزمة الديمقراطية. وبعد تداول ثلاثة أيام من الحجاج، عجز المؤتمر عن أن يُصدر حتى مجرد تصريح، ليس لأن حضوره اختلفوا، بل لأنهم كانوا لا يجرُؤون على التصريح بشيء، خشية من أن يُتّهموا من الأبواق التي صنعوها بخيانة وخروج عن الخط.
مهما يكن، صنعت تلك الحكومة مع أنصارها، كما علّقتُ في سانحة سابقة، معجزة تفوّقوا فيها على إنجازات نظام الإنقاذ (البشير)، إذ أنجزوا في ثلاثة أعوام من حصاد كراهية غالبية السودانيين الساحقة ما استغرق الإنقاذيون ثلاثين عاما لبلوغه!
تحقّقت هذه المعجزة بعجز كامل في مجال الاقتصاد والخدمات، وبضرباتٍ موجعةٍ وجهت إلى قطاع التعليم، فقد أمرت الحكومة بإغلاق كل المدارس والجامعات الحكومية في البلاد في فترة الجائحة، بل حاولت تعويق جهود الجامعات الخاصة التي أرادت الاستمرار في التعليم. ودعمت، أو عجزت عن وقف، التحرّكات الفوضوية التي كانت تقودها جهات متطرّفة موالية للحكومة لإغلاق الشوارع ومنع أي جهود لإعادة العملية التعليمية بحجج مختلفة، إلى درجة أن التعليم ظل متوقّفاً عدة سنوات متتالية. وبالطبع، كان إغلاق الشوارع بصورة دائمة، إضافة إلى تحويل عيش المواطن العادي إلى جحيم (كان من يصطحب مريضاً في حالة طارئة يستعطف الغوغاء ساعات حتى يتكرّموا بإعطاء مريضه فرصة للحياة، وكثيراً ما رفضوا)، فإنها كانت كارثة على اقتصادٍ يحتضر.
فاقمت الحكومة والقوى السياسية المهيمنة فيها هذا كله بعجز سياسي في توحيد القوى المدنية، بل الامتناع عن بذل أي جهد في هذا السبيل، مع الاعتماد على العسكر في تمديد الفترة الانتقالية بدون أفق. ورغم أن الفترة كانت مسمّاة انتقالية، بمعنى أن الغرض هو التمهيد لحكم مدني ديمقراطي، لم تتّخذ الحكومة أي خطوة نحو إصدار قانون انتخابات، أو إنشاء مفوّضية انتخابات، أو إجراء إحصاء سكاني بهدف تحديد الدوائر، فلم تكن الديمقراطية من همومها، فضلاً عن أن تكون أولوية.
مهّدت كل هذه الأخطاء والخطايا وجوانب الغفلة والتقصير لانفجار الصراع، فقد ابتعدت الفئة الحاكمة خلال “الانتقال” من التحرّك في أي اتجاه ديمقراطي، ولم تنتهز فترة شعبيتها المبكرة للتوجّه إلى الانتخابات، بل دلفت في اتجاه “شعبوي” على نهج الثورة الفرنسية أو القذّافية لفرض هيمنة غير منازعة على الساحة السياسية، ما زاد الاعتماد على العسكر، ثم على مليشيا الدعم السريع بعد خلافها مع قيادة الجيش. وكان التحالف الحاكم قد تشظّى، وتحالفت فئة منه مع المليشيا عبر ما سمّي “الاتفاق الإطاري” الذي حول المليشيا إلى جيش موازٍ مستقل عن الجيش، بدون أفقٍ لتوحيد الجيشين. بل كان المخطط إضعاف الجيش تمهيداً لإحلال المليشيا مكانه. أي أن مفهوم الديمقراطية عند هذه العصبة كان تنصيب قلة سياسية معزولة فاشلة، تحت جناح مليشيا قبلية مملوكة لأسرة واحدة، تحت هيمنة دولة أجنبية ضالعة في استبدادٍ يُخجِل هتلر. وعندما لم يساير الجيش هذا المخطّط، لجأت هذه الفئات للخطة “ب”، أي إزاحة الجيش أو على الأقل قيادته، من المشهد. وهو ما هدّدوا به علناً مراراً بترداد عبارة “الإطاري أو الحرب”، وهي خطّة بدت سهلة التنفيذ، كون المليشيا كانت تتحكّم فعلاً في مفاصل الدولة من القيادة العامة إلى القصر الرئاسي فمقرّات الأجهزة الأمنية ومحيط معسكرات الجيش، … إلخ.
انهارت هذه الخطة في ساعاتها الأولى، ما أحدث وضعاً فوضوياً استغلته المليشيا للترويع والنهب، ثم التغلغل بسرعة في الفضاءات المدنية، واحتلال الأحياء بيتاً بيتاً، وزنقة زنقة، وتهجير المواطنين قسرياً. ومن ذلك ارتكاب مجازر في الجنينة، خُطّط لها سلفاً كما اتضح من أنها انطلقت في اليوم السابق على الهجمة على مقر القيادة العامة للقوات المسلّحة في الخرطوم.
المفارقة أن العملية كلها سوّقت محاولة لاستعادة الحكم المدني، وانتزاع الحكم من الإسلاميين المتمترسين في الجيش. وكان سياسيو المرحلة ينسبون كل إخفاقاتهم إلى النظام السابق، سواء بإخفاء أموال في الخارج، أو التدخّلات السلبية، … إلخ. ولم تكن هناك حاجة لاجتهاد كبير لشيطنة نظام البشير، فقد كان موضع غضب شعبي، ولكن الفشل في تنفيذ وعود باستعادة الأموال المنهوبة … إلخ. كان له أثر سلبي. والمفارقة أن الحرب قلبت الموازين، خصوصاً بعدما بدأت ممارسات المليشيا وفظائعها تتفاقم، حتى مسّت كل بيت وأسرة، مع استمرار سياسيي الفترة الانتقالية في الدفاع عنها والصمت عن إدانة هذه الفظائع، رغم أن كثيرين من أنصار هذه الفئة كانوا في طليعة الضحايا.
الخلاصة أن هذه الحرب شُنّت بحجة استعادة الديمقراطية وإقصاء الإسلاميين لصالح قوى سياسية لم تحقّق في تاريخ الفترات الديمقراطية عشرة مقاعد برلمانية، ولكنها تمتّعت بشعبية مؤقته بسبب معارضتها نظام الإنقاذ. ولم تكن هناك حاجة لإقصاء الإسلاميين، لأن نظامهم سقط، وكانت شعبيّته أدنى من الصفر حين شُنّت الحرب. إلا أن الحرب نسفت الشعبية المحدودة والهشّة لمن خطّطوا لها، تحديداً بسبب مواقفهم المؤيدة لفظائع المليشيا. إلا أن ما يسمّى الرباعية، ومن ضمنها حلفاء مهووسون بإنهاء وجود الإسلاميين، حتى ولو كان الثمن إبادة شعب بكامله في غزّة أو السودان، مع مطالبةٍ بـ”سلام” يضم المليشيا البربرية إلى السلطة في السودان، وتمويل جنودها من أموال الشعب وخزينة الدولة. وهي المنظّمة الإجرامية نفسها التي هجّرت نصف أهل السودان من مواطنهم في غرب دارفور والعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وما حولها، وأخيراً من الفاشر وباقي أرجاء دارفور. ولو انتصر وعيدها باستمرار الحرب، فإنه سيهجّر النصف الآخر.
والصحيح لن يكون هناك سلام مع وجود المليشيا، ولا خيار للسودانيين للحفاظ على وطنهم سوى التكاتف لإعادة مرتزقتها من حيث أتوا، ولا خيار للعرب والمجتمع الدولي سوى دعمهم، فالعالم لن يستطيع استيعاب أربعين مليون مهاجر إضافي من بلد كان المأوى الأكبر للاجئين في أفريقيا. وعلى إسلاميي السودان استيعاب الدرس وتوحيد الصف الوطني. وعلى من كانوا ينتظرون ديمقراطية حميدتي أن ينضمّوا بدورهم إلى الصف الوطني، وإلا لا يصلّون العصر إلا في الفاشر حتى لا يفوتهم الاستمتاع بتلك الديمقراطية التي تمتع بها نزلاء المستشفى السعودي في الفاشر، والتي اختار ربع مليون فاشري الفرار منها، لإن “إسلاميين فاشيين” لا يحبّون الديمقراطية والحرية.