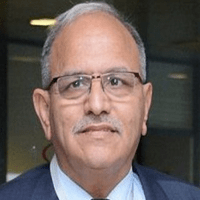طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت
حسني عايش
حرير- لم يترك اليهود في إسرائيل / فلسطين أداة أو وسيلة استخدمت ضدهم في عصور الاضطهاد الأوروبي أو النازية، إلا واستخدموها لاضطهاد الشعب الفلسطيني بها، وأضافوا إليها ما ابتكروه منها في إسرائيل، الشعب البريء تاريخياً من أي اضطهاد لهم، الذي استقبلهم بترحاب عندما فروا إليه من أوروبا لاجئين في وضع مزرٍ، ومع هذا فقد اغتصبوا وطنه وشردوه في وطنه وفي خارجه عقداً وراء آخر إلى اليوم. وبما أنه يقاوم هذا الاضطهاد ويتمرد عليه، فإنهم مشغولون على مدار الساعة بأمرين:
• بتطفيش ما بقي منه في وطنه.
• وقمع الباقين الصامدين بتلك الأدوات والوسائل كيلا يفتحوا فمهم، وإنما لينسوا النكبة والكارثة ويحتفلوا بأعياد إسرائيل دون أن ينالوا أي حق من حقوق الإنسان.
مقابل هذه الإستراتيجية الإسرائيلية التي لا مثيل لها في التاريخ المعاصر نشأ عند كل فلسطيني العكس، أي المقاومة والصمود، والحب الاستثنائي لفلسطين، واستعداد لا مثيل له عنده للتضحية بالنفس، بالحياة ، من أجل تحريرها مهما طال الزمن. صارت التضحية فعل مقدس.
وبما أن إجراءات إسرائيل القمعية للشعب الفلسطيني لا تتوقف كماً ونوعاً، فإنها تدفع الفلسطيني إلى المزيج من التضحية والتعلق بفلسطين إلى درجة العشق بمقدارهما، سواء أكان مؤمناً أو علمانياً أو كافراً، فشعب فلسطين والتضحية من أجلها هو الجامع المشترك الأعظم عندهم.
لقد أصبحت التضحية عندهم يومية. صارت طريقة حياة، أو الفضيلة الشخصية التي يتمتع بها كل منهم كمصدر لكل معنى. ويتجلى هذا الارتباط العضوي بين حب الوطن والتضحية بالطقوس التي تقام للبطل/ الشهيد في كل مرة، وكـأنه عريس يزف لا قتيلا يدفن، فأمه وأخواته يزغردن ولا يبكين، والرفاق يحملونه على الأكتاف يهجزون ويغنون، وكأنهم ذاهبون به إلى حمام العريس، وليس إلى المقبرة. حقاً إنها زفة لا مناحة، ثم قصص ورايات تمجد الشهيد الذي لا يموت، وهي طقوس لا مثيل لها في العالم.
هذه اللحظة تدعوني إلى وصف كل من يدعي أن الشعب الفلسطيني باع أرضه لليهود بالجهل أو بالحقارة، أو بالعمالة، ذلك أن كل ما ملكه اليهود من أرض فلسطين حتى خروج بريطانيا منها في الخامس عشر من أيار سنة 1948، كان أقل من سبعة في المائة حسب سجلاتها الأرضية التي يمكن الاطلاع عليها في مركز الأمم المتحدة في نيويورك. وقد تكون معظم هذه النسبة من الأراضي الأميرية ومن أراضٍ باعها إقطاعيون لبنانيون وسوريون من رواسب الحكم العثماني. وعليه فعلى صاحب هذا الاتهام مراجعة التاريخ فلعله يجد أن بلده شريك في تضييع فلسطين لصالح إسرائيل.
ومع أن إستراتيجية إسرائيل كالتي ذكرت فإن كل ما تمارسه منها كمياً ونوعياً يسقط تحت الأقدام الفلسطينية، ويؤدي إلى عكسه. لا يعني ذلك إنكار الرعب والفزع المرافقين لتلك الإستراتيجية في حالة الاقتحام، بل يعين رؤيتهما في إطار تضحوي.
تعرف إسرائيل أن بيت الفلسطيني التاريخي أو الحديث هو أغلى ما يملك، فهو وطنه الصغير في إطار وطنه الكبير فتهدمه لتبكيه، وتعرف أن أرضه عزيزة مثله عليه فتصادرها، لتفاجأ بمقاومة نوعية يقوم بها أبناء الجيل الفلسطيني الرابع.. مقاومة لا تخطر على بالها، وليس على استسلام لها يفرحها ويسليها. إن قمعها يرفع منسوب حب الوطن والأرض عند الفلسطيني، والاستعداد للتضحية، وبعيون تناطح المخرز، فتكسره.
يوصف اليهود بالذكاء وحتى بالعبقرية، لكن إستراتيجية إسرائيل هذه تنبئ عن غباء شديد لأنها تنعكس سلبياً عليها وهي تعتقد العكس، فالفلسطيني بدلاً من أن يهرب نتيجة لها يثبت، وبدلاً من أن يسكت يقاوم، وبدلاً من أن يبكي يبتسم، وبدلاً من أن ينجو يقدم حياته فداء للوطن.
لو كانت إسرائيل تعقل وتفكر لتعاملت مع الشعب الفلسطيني على أسس الحق والعدل والسلام، وبكل الود ليرضى، ولكنها لا تعقل ولا تفكر بإصرارها على القمع والاضطهاد والإبادة كحل نهائي، لكن ذلك يقابل بحل معاكس، وهو المقاومة المستدامة، وحرمان اليهود ليس من الشعور بالأمن فقط وإنما بالقلق الوجودي الدائم والمتصاعد مع كل حالة قمع. وهكذا صار الأمن مشكلة إسرائيل الرئيسة أو الوحيدة، وكل أدواتها ووسائلها وإجراءاتها القمعية لتوفيره، فلا يتوافر.
وبما أن الأمن والقلق في حالة جدل لا تتوقف فإن إسرائيل تزيد الجرعة الأمنية، لتواجه بمقاومة لا تخطر على البال فيشتد القلق، فتلجأ إلى المزيد من القمع والاضطهاد، وحتى الإبادة الجماعية، ومحو فلسطين اسماً وشعباً من الوجود لتوفير الأمن، فتفاجأ بطوفان الأقصى، ويبلغ القلق الفردي والجمعي عندها ذروته، وهكذا.
إسرائيل لا تعقل ولا تفكر لأنها لا تتعلم من قانون نيوتن (اليهودي) أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، وأن رد الفعل في السياسة والاجتماع والحرب قد يكون أكبر بكثير من الفعل نفسه، وهو ما تقوم به إسرائيل الآن في ردها على طوفان الأقصى، الذي سيؤدي حتماً– يوماً– إلى رد فعل عليه أقوى منه.
ولأن إسرائيل منشغلة على مدار الساعة بتوفير الأمن والرفاهية لليهود فيها، فقد أضعفت ميلهم نحو المقاومة: المقاومة بالمقاومة. صاروا جميعاً يتكلون على التكنولوجيا في توفير الأمن، فغابوا عن المسرح، فلا يتطوع أحد منهم للمقاومة، مكتفين بالتجنيد الإجباري النظامي والاحتياطي التقني– عن بعد– مقابل تعويض مادي مجزٍ، مقابل مقاومة فلسطينية من المتطوعين بالنفس والحياة في سبيل الوطن، ودون أي مقابل دنيوي. وعليه فإن ردهم على المقاومة الفلسطينية آيل إلى النضوب، مقابل المقاومة الفلسطينية المستدامة أي التي لا تنضب. لقد انشغلوا بمباهج الحياة في فلسطين التي وفرها لهم الاغتصاب والتشريد، فصاروا أشبه بمقيمين في فنادق من مستوى سبعة نجوم، فمات حسهم الفردي والجمعي نحو التضحية.
انظر كيف فر مئات الآلاف منهم إلى الخارج مع أول «طقطقة» في غزة، وانظر إلى حرص كل من يحمل جواز سفر آخر أو أكثر ليفر عند اللزوم، وانظر إلى ذوي الأسرى عند المقاومة، كيف يقيمون القيامة ضد الحكومة لاستعادتهم.
لعل هذا وذاك يعنيان أن اليهودي المترف في إسرائيل صار غير مستعد لخدشٍ أو لجرحٍ من أجل المجموع فكيف يموت من أجله؟!
يبدو أن كل الأسوار والتحصينات والكاميرات والطرق الالتفاتية والحواجز الثابتة والطيارة، والاعتقال والسجن حتى للأطفال الذين ضربوا حجراً على جيب عسكري، ودفن المرضى والجرحى أحياء في التراب، والإبادة الجماعية أشبه بساتر من الرصاص، لكنها لا توفر لهم الأمن، بغياب رضا الفلسطينيين عنهم. إن مصيرهم صائر إلى ما صار مصير الظالمين إليه في كل مكان، وهو الاندثار والزوال عاجلاً أو آجلاً بالتوراة والصهيونية نفسيهما.
أما الشعب الفلسطيني فهو مثل طائر الفينيق الأسطورة الذي ينهض في كل مرة حياً من الرماد من جديد. مرة بعد مرة فلا يزول ولا يزال.