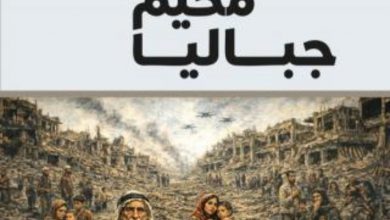حين يطالب البعض أن يكون احد القيادات عضو بلجنة السلام كي تنجح
المخرج والكاتب السينمائي يحيى بركات
هناك لحظة في السياسة يصبح فيها الصمت خيانة للعقل.
وحين لا يعود الخطر في العدو وحده، بل في اللغة التي يتحدث بها بعضنا عن العدو، يصبح الكلام واجبًا لا خيارًا.
كل ما يجري اليوم واضح.
ليس بحاجة إلى محلّل عبقري، ولا إلى قراءة سرّية للوثائق.
تصريحات ترامب، خطابات نتنياهو، مداولات المؤتمرات الإسرائيلية، وممارسات الاحتلال في غزة والضفة…
كلها تقول الشيء نفسه، بصوت واحد:
الفلسطيني لم يعد طرف صراع، بل مادة إدارة.
ومع ذلك، يظهر من بيننا من لا يرى المشكلة في هذا كله،
بل يرى الخلل في تفصيل واحد فقط:
أن اللجنة التي أعلنها ترامب لا تضمّ أحدًا من قيادة السلطة الفلسطينية.
هنا يجب أن نتوقف طويلًا.
من يطالب بأن يكون رئيس السلطة الفلسطينية، أو نائبه، أو عضوًا في اللجنة المركزية، أو رئيس الوزراء، عضوًا في اللجنة التي يرأسها ترامب،
لا يطالب بتمثيل فلسطيني،
بل يطالب بمنح هذه اللجنة شرعية فلسطينية.
الفارق ليس لغويًا.
الفارق وجودي.
هذه المطالبة لا تعني
“تصحيح الخلل”،
بل تعني القبول بالمشروع من أساسه،
ثم التفاوض على شكل المشاركة فيه.
هذا الخطاب لا يقول:
هذه لجنة احتلال ويجب إسقاطها.
ولا يقول:
هذه إدارة مفروضة لتصفية السياسة الفلسطينية.
ولا يقول:
هذه محاولة لاستبدال التحرر بالإدارة.
بل يقول، عمليًا:
اجعلوا الاحتلال أكثر قبولًا عبر إشراك فلسطيني فيه.
وحين يُطلب من رئيس الشعب الفلسطيني أن يجلس في لجنة يرأسها ترامب،
وتُدار من واشنطن،
وتعمل وفق الشروط السياسية والأمنية التي أعلنتها إسرائيل،
فهذا لا يعني “حضورًا فلسطينيًا”،
بل يعني تحويل القيادة الفلسطينية إلى جزء من بنية صاغها المشروع الصهيوني نفسه.
قد يُقال إن النية حسنة.
لكن السياسة لا تُقاس بالنوايا، بل بالنتائج.
حين تجلس في بنية صاغها العدو،
تحت سقفه،
وبشروطه،
وبتفويضه،
أنت لا “تؤثر من الداخل”…
أنت تمنح الداخل شرعية.
وهذا أخطر أشكال الانزلاق.
اللافت، والمؤلم،
أن من يطرح هذا الطرح لا يدعو إلى إسقاط اللجنة،
ولا إلى تحذير الشعب منها،
ولا إلى حشد القوى الوطنية ضدها،
ولا إلى إعادة بناء الحامل السياسي الفلسطيني.
مشكلته الوحيدة معها أنها
“ناقصة فلسطينيًا”.
وكأن المشكلة ليست في كونها صهيونية،
بل في كونها لم تُطعَّم بوجه فلسطيني.
هذا ليس غباءً سياسيًا.
هذا تطبيع ذهني.
هو انتقال كامل من سؤال:
كيف نواجه مشروع التصفية؟
إلى سؤال:
كيف نكون جزءًا منه دون أن نُهان؟
وهنا تحديدًا، يصبح الخطر داخليًا.
التاريخ لا يرحم هذا النوع من المواقف.
الانتداب البريطاني لم يبدأ بالدبابات فقط،
بل بالمجالس واللجان والوجوه المحلية التي أُدخلت إلى الإدارة
بحجة “العقلانية” و”حماية الناس”.
كل من دخل تلك البنى باسم الواقعية
خرج منها بلا كرامة ولا أثر وطني.
اليوم، المشهد أكثر فجاجة.
الاحتلال لا يختبئ خلف لغة حضارية.
هو يقول بوضوح:
الضفة انتهت.
غزة يجب إعادة تشكيلها.
الاستيطان هو الحل.
والسياسة الفلسطينية يجب أن تُدار لا أن تُمارَس.
وفي المقابل،
بدل أن يكون الرد:
هذه لجنة احتلال، وسنُسقطها،
يخرج من يطالب بأن يكون رئيس الشعب عضوًا فيها.
أي انقلاب أخطر من هذا؟
أي لحظة سقوط أعمق؟
ليس الخطر أن يطرح ترامب هذا المشروع.
الخطر أن يُطالَب الفلسطيني بأن يمنحه شرعية.
وهنا يجب أن يُقال الأمر بلا مواربة:
من يطالب بضمّ الرئيس أو القيادة الفلسطينية إلى لجنة يرأسها ترامب،
يطالب — سياسيًا، مهما حسنت نواياه —
بأن يكون فلسطينيًا داخل مشروع صهيوني.
وهذا هو الخط الأحمر الذي لا يجوز عبوره،
ولا السكوت عنه،
ولا تغليفه بلغة الاحترام أو الواقعية.
القضية لم تعد اختلاف آراء.
القضية:
إما سياسة تحرر…
أو إدارة تحت الاحتلال.
وما بينهما،
لا توجد منطقة وسطى.
يحيى بركات