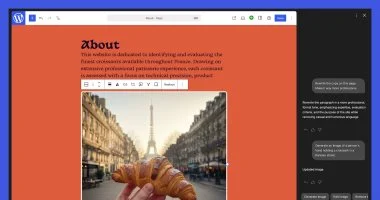بعد حظر روابطها.. PixelFed تطلق تطبيقاً للهواتف الذكية
حرير- أطلقت منصة “بيكسل فيد” (PixelFed) لمشاركة الصور تطبيقها للهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل أندرويد وiOS، وذلك لتكون منافس جديد في وجه إنستجرام.
خرجت المنصة الاجتماعية إلى النور في عام 2018، وكانت تقدم خدماتها عبر موقع الويب فقط، إلى جانب تطبيقات للموبايل من شركات طرف ثالث، بينما يُعد تقديمها لتطبيق رسمي على الهواتف خطوة فارقة في سوق التواصل الاجتماعي.
تعمل المنصة بأسلوب اللامركزية (Decentralisation)، إذ تسمح للمؤسسات والمستخدمين بإنشاء خوادمهم الخاصة لاستضافة محتوى المنصة، وفق قواعدهم الخاصة، كما أن PixelFed لا تجمع بيانات المستخدمين ولا تعرض لهم محتوى إعلاني على متنها.
وتتشابه واجهة استخدام PixelFed كثيراً مع إنستجرام، من حيث مساحات عرض المحتوى Feed، وكذلك ترتيب أزرار التفاعل وتصميم المنشورات من حيث المساحة الكبيرة لعرض الصور، والمساحة المحدودة للنصوص أسفلها، إلى جانب التشابه على مستوى تصميم الصفحات الشخصية للمستخدمين.
تجربة مفتوحة
تتيح المنصة للمستخدمين القدرة على اختيار الخادم الذي يرغبون في إنشاء حساباتهم على متنه، بعد تحميل التطبيق على هواتفهم.
بعد اختيار الخادم، سيتمكن المستخدم من إنشاء حسابه إما باستخدام حسابه على منصة “ماستودون” (Mastodon) أو من خلال إنشاء حساب جديد باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص به.
وقال مؤسس PixelFed دانييل سوبرناولت إن المنصة انضم إليها 11 ألف مستخدم جديد خلال 24 ساعة، منذ إطلاق التطبيق على متجر آب ستور App Store الأحد الماضي، وقد تمت مشاركة 78 ألف منشور حتى الآن على خادم Pixelfed.social فقط، بحسب ما شاركه عبر حسابه على “ماستودون”.
وتدعم المنصة الاجتماعية اللامركزية بروتوكول ActivityHub الشهير، وهو نفسه الذي تدعمه المنصات الاجتماعية اللامركزية مثل ماستودون وFlipboard.
يُذكر أن المنصة الاجتماعية اجتذبت قطاع كبير من مستخدمي إنستجرام، وذلك بعد أن غيّرت “ميتا” من سياساتها الخاصة بالمحتوى المصنف “خطاباً للكراهية”، إلى جانب إيقاف جهودها الخاصة بتدقيق الحقائق، بالتعاون مع مؤسسات خارجية.
وحظرت “ميتا” مشاركة روابط حسابات المستخدمين لدى PixelFed داخل حساباتهم على إنستجرام، معتبرة هذه الروابط بأنها “محتوى مزعج”، واتخذت قراراً بحذف المنشورات التي تتضمنها.
فيما أشار المتحدث باسم “ميتا” إلى أن حذف روابط PixelFed وقع بطريق الخطأ، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تصحيحه.
يُذكر أن ميتا قد اتخذت خطوات واسعة نحو دعم منصاتها الاجتماعية لفكرة اللامركزية في تخزين بيانات المستخدمين، فمنصتها “ثريدز” (Threads) الاجتماعية وسعت سياق توافقها مع منصة ماستودون الاجتماعية.
وأصبح بإمكان مستخدمي “ثريدز” تصفح المحتوى على ماستودون ومتابعة الحسابات على متنها، بل واقتراح محتوى ثريدز على ماستودون، والعكس كذلك، مما جعل ثريدز جزءًا من العالم الاجتماعي اللامركزي.